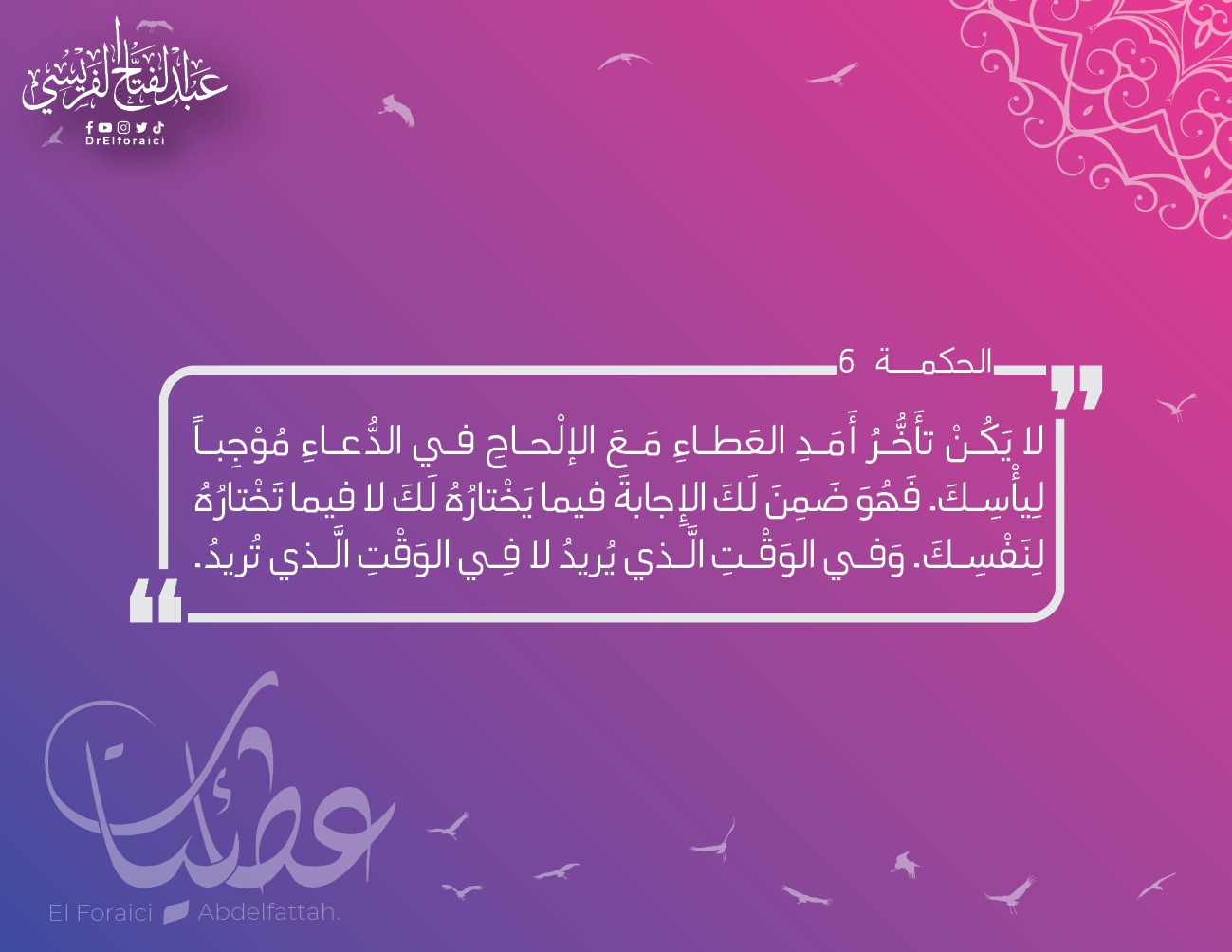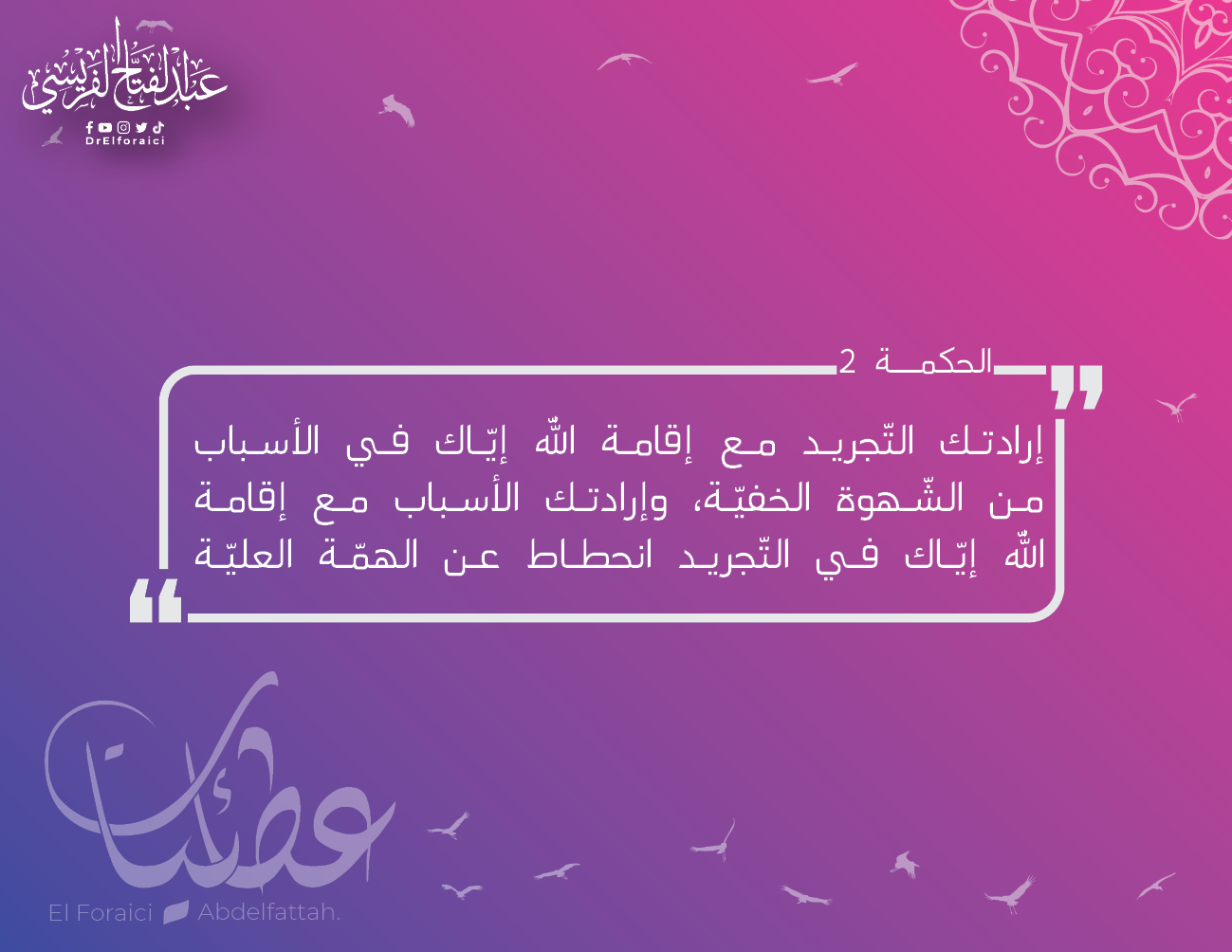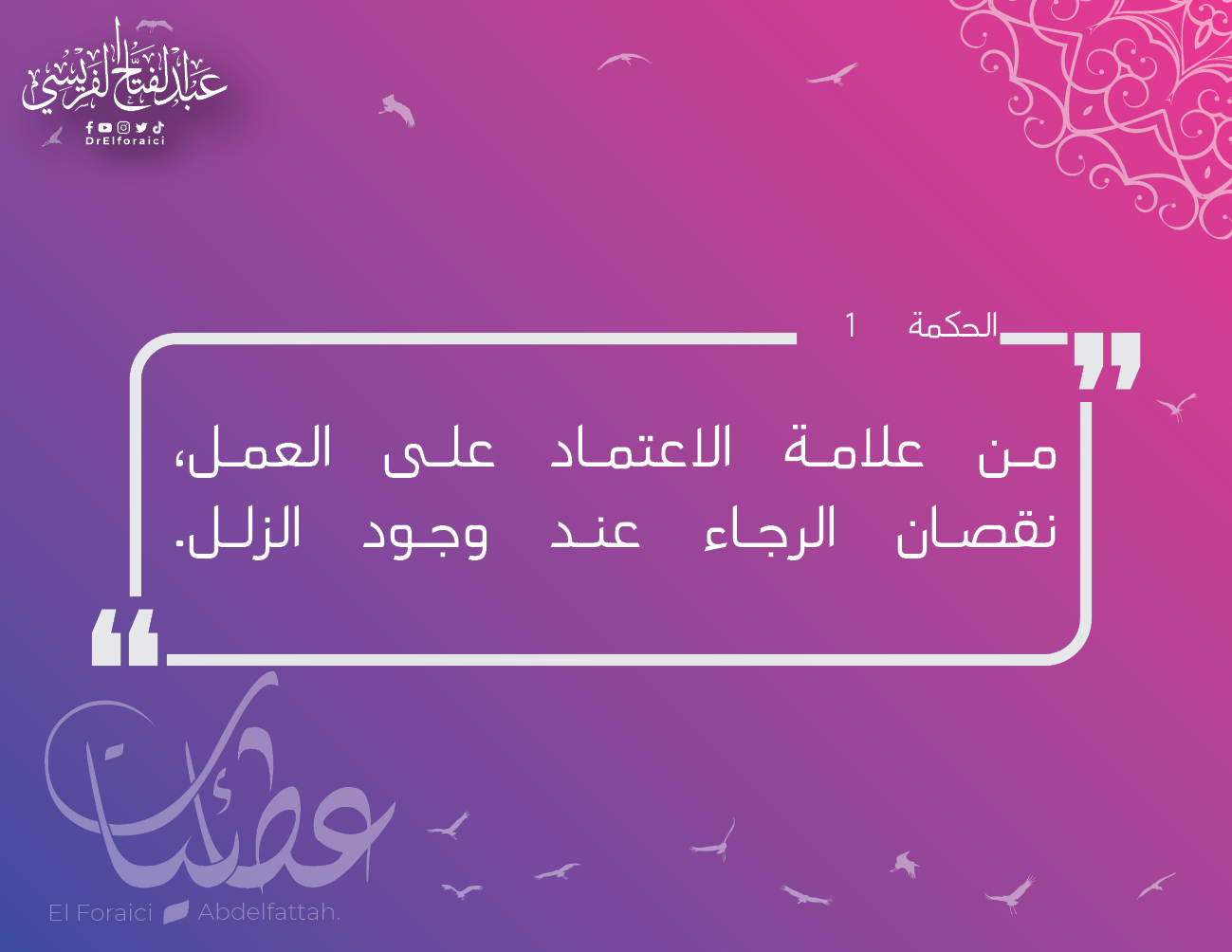Category: عطائيات
الحكمة في المنظور الإسلامي
قد قال تعالى: “يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ ۚ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ” البقرة 269، قال أبو جعفر الطبري: يعني بذلك جل ثناؤه: يؤتي الله الإصابة في القول والفعل من يشاء من عباده، ومن يؤت الإصابة في ذلك منهم، فقد أوتي خيرا كثيرا، وقال جمهور المفسرين: الحكمة فهم القرآن والفقه به، وقيل هي النبوة، وقيل الخشية، إلى غير ذلك من الأقوال، ولا تعارض بين ذلك كله، لأن الإصابة في الأمور إنما تكون عن فهم بها وعلم ومعرفة، وإذا كان ذلك كذلك ، كان المصيب عن فهم منه بمواضع الصواب في أموره ، فهما خاشيا لله : فقيها عالما، وكانت النبوة من أقسامه؛ لأن الأنبياء مسددون مفهمون، وموفقون لإصابة الصواب في بعض الأمور، والنبوة بعض معاني الحكمة، ومعنى الآية: إن الله يؤتي الصواب في القول والفعل لمن يشاء، ومن أحب من خلقه، ومن يؤته الله ذلك فقد آتاه خيرا كثيرا، وقد ورد في القرآن الكريم، أن الحكمة عطية ربانية ومحة إلهية، يوتيها الله لمن شاء من عباده، من الأنبياء والصالحين.
والحكمة في اللغة: اللجام الذي يوضع في فم الفرس، سُمِّي بذلك؛ لأنَّه يمنعه الفرس من الجماح والجري الشَّديد، ويذلِّل الدَّابَّة لراكبها[1]، ومن هذا المعنى اشتقت كلمة “الحِكْمَة”، وهي تعني معرفة حقائق الأمور، فتمنع صاحبها من الوقوع في الخطإ والباطل، قال أبو إسماعيل الهروي: (الحِكْمَة اسم لإحكام وضع الشيء في موضعه[2]، وقال الإمام النَّووي: (الحِكْمَة، عبارة عن العلم المتَّصف بالأحكام، المشتمل على المعرفة بالله تبارك وتعالى، المصحوب بنفاذ البصيرة، وتهذيب النَّفس، وتحقيق الحقِّ، والعمل به، والصدِّ عن اتِّباع الهوى والباطل، والحَكِيم من له ذلك)[3] ، كما تطلق “الحكمة” كذلك على لون من التعبير هو خلاصة نظر عميق إلى الأشياء إلى الحياة، وما يضطرب فيها من أفكار، تصدر عن ذوي التجارب الغنية، والعقول الراجحة والأفكار النيرة، وقائلها يوصف حكيما، لأنه ينظر إلى الأشياء بعين الشمولية والتحليل الدقيق، ثم يصدر في شأنها حكما ينتشر لفظه على ألسنة الناس، ويبقى مذكورا يعلق بالأذهان والنفوس، يجدون فيه الهداية والتوجيه إلى ما يعينهم وينفعهم في الحال والمآل.
وتمتاز “الحكمة” اللفظية بالإيجاز وسبك الصياغة، وقوة التعبير، ويلزم منها في الأصل أن تكونَ صحيح المنحى، وهذا هو الفرق بينها وبين المثل، فالمثل قد يَشتهر ويكون معناه غير مسلم به، بخلاف الحكمة، فإنها وليدةُ فكر ناضج، وعقل متميز، يضع الكلمة في موضعها، والعبارة في سياقها، ومن أمثلة الحكم قوله:”إنك لا تجني من الشوك العنب”، وقولهم: “إن كنت ريحا فقد لاقيت إعصارا”، وقولهم: “مصائب قوم عند قوم فوائد”، وفي الدارج المغربي قولهم: “كون سبع وكلني” ، وقولهم: “اللي بغا الزين يصبر على ثقيب الوذنين”.
الحكمة في القرآن الكريم والسنة النبوية:
• الحكمة في القرآن الكريم:
وردت كلمة “الحكمة” معرفة بـ“أل“ أو نكرة في القرآن الكريم 20 مرة؛ أولها قوله تعالى: (رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) [سورة البقرة: 129]، ومن ذلك قوله تعالى: (يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلا أُولُو الأَلْبَابِ) [سورة البقرة: 269]، وآخرها قوله تعالى: (هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ) [سورة الجمعة: 2].
وجاءت “الحكمة” مقترنة بكلمة “كتاب” في 10 مواضع في آيات شتّى؛ منها قوله سبحانه: (أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا) [النساء: 54]، ونصيب محمد ﷺ من تلك الآيات العشرين هو في 6 مرات، ولا غرو في ذلك؛ لأن هذا ببركة دعاء إبراهيم عليه السلام أن يرزقهم نبياً يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكّيهم، وعن معنى الحكمة في القرآن الكريم يقول ابن عاشور: “فالحكمة هي المعرفة المحكمة، أي الصائبة المجردة عن الخطأ، فلا تطلق الحكمة إلا على المعرفة الخالصة عن شوائب الأخطاء وبقايا الجهل في تعليم الناس وفي تهذيبهم. ولذلك، عرّفوا الحكمة بأنها معرفة حقائق الأشياء على ما هي عليه بحسب الطاقة البشرية، بحيث لا تلتبس على صاحبها الحقائق المتشابهة بعضها ببعض ولا تخطئ في العلل والأسباب، وهي اسمٌ جامعٌ لكل كلامٍ أو علمٍ يراعى فيه إصلاح حال الناس واعتقادهم إصلاحاً مستمراً لا يتغير”.
• الحكمة في السنة النبوية:
قد وردت كلمة ”حكمة“ في الحديث النبوي، ومن ذلك ما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: “قال النبي صلى الله عليه وسلم: (لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسُلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها)”[4]، وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: “ضمّني النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره، وقال: (اللَّهُمَّ عَلِّمْه الحِكْمَةَ وَتَأْوِيلَ الْكِتَابِ)”[5]، وكذلك روي عن أُبي بن كعب رضي الله عنه، أن رسول الله قال: (إن من الشعر حكمة)”[6]، قال ابن حجر العسقلاني: “قوله: (إن من الشعر حكمة) قولا صادقا مطابقا للحق. وقيل: أصل الحكمة المنع، فالمعنى إن من الشعر كلاما نافعا يمنع من السفه”[7].
فهذه جملة الأحاديث الصحيحة التي وقفت عليها وهناك أحاديث غيرها ترد على ألسنة الناس لكنها ضعيفة، وأشهرها ما روى الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ : (الكلمة الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بها)، قال الترمذي، وهذا حَدِيثٌ وإن كان ضعيفا عند المحدثين، وفي سنده مقال، فإن معناه صحيح، وتقويه الأحاديث الصحيحة السابقة، وتشهد له نصوص الإسلام وروحه ومقاصده، وذلك أن المؤمن لا يزال طالبا للحق حريصا عليه، فكل من قال بالصواب أو تكلم بالحق قبلنا قوله وإن كان خصما أو عدوا، وقد قال تعالى:{ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا} المائدة:8، والعاقل يأخذ الحكمة من أي وعاء خرجت وعلى أي لسان ظهرت.
وفي الختام نقول إن حاجتنا اليوم ماسة لإحياء معالم علم التربية على التصوف النافع، والسلوك الصالح، المبني على الدليل، والمؤسس على الوسطية والاعتدال، مرتكزا ومجالا، وعلى عقيدة السلف الواضحة الناصعة.
وإن حاجة المشتغلين بفقه الفروع اليوم محتمة للانفتاح على مبادئ التربية والسلوك والمعارف الصوفية السنية النقية، فذلك أدعى أن يكون لقولهم أثر، ولجهدهم نفع، كما أن المشتغلين بالتصوف والمعارف الروحية مطالبون اليوم أيضا بمد جسور الحوار والانفتاح على الفقه والعلم الشرعي، فهما وتنزيلا، ليكون السير على بصيرة، والتربية على علم، ولا تعارض بين المنهجين، إلا في أذهان المتعصبين أشباه العلماء في الفريقين، فالحق لا يضاد الحق، بل يشهد له، كما جاء عن ابن رشد.
روي عن الإمام مالك رحمه الله تعالى: «من تفقه ولم يتصوف فقد تفسق ومن تصوف ولم يتفقه فقد تزندق ومن جمع بينهما فقد تحقق »، ويقول أبي القاسم الجنيد رحمه الله: “طريقتنا هذه مربوطة بالكتاب والسنة”، وقال أيضا: ”الطرق كلها مسدودة على الخلق إلا من اقتفى أثر الرسول عليه الصلاة والسلام“ وقال: «من لم يحفظ القرآن ولم يكتب الحديث لا يُقتدى به في هذا الأمر لأن علمنا هذا مقيد بالكتاب والسنة».
ــــــــــ هوامش ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. القاموس المحيط للفيروز أبادي: ص1415، لسان العرب لابن منظور 12/143، مختار الصحاح للرازي: ص 62 ، النهاية في غريب الحديث لابن الأثير: 1/119، المصباح المنير للفيومي: 1/145، تاج العروس للزبيدي: 8/253، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 1/288،
2. منازل السائرين للهروي: 78
3. شرح النووي على مسلم:2/33
4. رواه البخاري، كتاب العلم، باب الاغتباط في العلم والحكمة، رقم الحديث: 73
5. رواه ابن ماجة، باب فضل ابن عباس، رقم: 166.
6. فتح الباري، ابن حجر العسقلاني، باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء وما يكره منه، دار الريان للتراث، سنة النشر: 1407ه-1986م، ح:1، ص: 554.
7. المصدر نفسه، ص: 556.
الحكمة: 6
لما كانت الغاية من الدعاء إنما هي حصول المراد، نبّه ابن عطاء الله السكندري هنا إلى خطورة استعجال ثمرته إبّان الدعاء، والإلحاح في ذلك، وينسى هذا الإنسان المستعجل أن الله الحي القيوم على مصالح عباده قد جعل لكل شيء أجلا محددا ووقتا معلوما في علمه سبحانه، تتحقق به مصلحة الناس وسعادتهم، قال تعالى: “فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستعجلون”.
يقول ابن عطاء الله السكندري : “لا يَكُنْ تأَخُّرُ أَمَدِ العَطاءِ مَعَ الإلْحاحِ في الدُّعاءِ مُوْجِباً لِيأْسِكَ. فَهُوَ ضَمِنَ لَكَ الإِجابةَ فيما يَخْتارُهُ لَكَ لا فيما تَخْتارُهُ لِنَفْسِكَ. وَفي الوَقْتِ الَّذي يُريدُ لا فِي الوَقْتِ الَّذي تُرْيدُ”، والإلحاح فى شىء ما هو: تكرره على وجه واحد، والدعاء هو: طلب مصحوب بأدب فى بساط العبودية لجناب الربوبية والموجب للشىء ما كان أصلا فى وجوده، و اليأس قطع المطامع.
والمؤمن يتعلق قلبه بمسألة يرجوها أو حاجة يرغب فيها ولكنه يتأدب في ذلك مع القدر والقضاء ويرجع فيه إلى وعد الله وعلمه، وهو حين يدعو يجعل دعاءه عبودية خالصة لا يخرمها عدم تحقق مطلوبه، أو تأخر مرغوبه، فهو يحمل همّ الدعاء وليس همّ الإجابة، لإن دوره أن يتقرب إلى ويدعو بما يعتقد صلاحه، ويترك لربه الإجابة لما يعلمه في ذلك.
و قد يمنعك لطفاً بك لكون ذلك المطلب لا يليق بك و يؤخر لك ذلك لدار الكرامة و البقاء و هو خيرا لك و ابقى، والمؤمن لا ييأس من مطلوبه أبدا، لأن الله طلب منا الدعاء أزلا، وضمن لنا الإجابة، ولكن الإجابة قد تتأخر عن وقتها وقد لا تتحقق رحمة بالإنسان المعروف بعجزه عن معرفة مصالحه، وفقه أموره قال تعالى: “وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة” القصص
وقد بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن كل دعوة يدعو بها المؤمن فهي مستجابة ولكن بإحدى ثلاث طرق، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخدري رضي الله عنه ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُو بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيهَا إِثْمٌ ، وَلَا قَطِيعَةُ رَحِمٍ ، إِلَّا أَعْطَاهُ اللهُ بِهَا إِحْدَى ثَلَاثٍ : إِمَّا أَنْ تُعَجَّلَ لَهُ دَعْوَتُهُ ، وَإِمَّا أَنْ يَدَّخِرَهَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ ، وَإِمَّا أَنْ يَصْرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا . قَالُوا : إِذًا نُكْثِرُ . قَالَ : اللهُ أَكْثَرُ ).
وختاما الشيخ عبد العزيز المهدوي رضى الله عنه : “من لم يكن فى دعائه تاركاً لاختياره، راضياً باختيار الحق تعالى له، فهو مستدرج ممن قيل له اقضوا حاجته فإنى أكره أن أسمع صوته، فإن كان مع اختيار الحق تعالى لا مع اختياره لنفسه كان مجاباً و إن لم يعط ، والأعمال بخواتمها“.
الحكمة: 5
الإجتهاد في الشيء إستفراغ الجهد والطاقة في طلبه، والتقصير هو التفريط والتضييع، والبصيرة ناظر القلب كما أن البصر ناظر القالب.
فإذا أراد الله فتح بصيرة العبد أشغله في الظاهر بخدمته وفي الباطن بمحبته ، فكلما عظمت المحبة في الباطن والخدمة في الظاهر قوي نور البصيرة ، حتى يستولى على البصر فيغيب نور البصر في نور البصيرة فلا يرى إلا ما تراه البصيرة من المعاني اللطيفة والأنوار القديمة.
وإذا أراد الله خذلان عبده أشغله في الظاهر بخدمة الأكوان وفي الباطن بمحبتها ، فلا يزال كذلك حتى ينطمس نور بصيرته فيستولى نور بصره على نور بصيرته ، فلا يرى إلا الحس ولا يخدم إلا الحس ، فيجتهد في طلب ما هو مضمون من الرزق المقسوم ويقصر فيما هو مطلوب منه من الفرض المحتوم.
قال الشيخ زروق وقال الشيخ أبو الحسن رضي الله عنهما: البصيرة كالبصر ، أدنى شيء يقع فيه يمنع النظر، وإن لم ينته إلى العمى، فالخطرة من الشيء تشوش النظر وتكدر الفكر، والإرادة له تذهب بالخير رأساً والعمل به يذهب عن صاحبه سهماً من الإسلام فيما هو فيه ويأتي بضده ، فإذا أستمر على الشر تفلت منه الإسلام فإذا انتهى إلى الوقيعة في الأمة وموالاة الظلمة حباً في الجاه والمنزلة ، وحباً للدنيا على الآخرة ، فقد تفلت منه الإسلام كله ، ولا يغرنك ما توسم به ظاهراً فإنه لا روح له إذ الإسلام حب الله وحب الصالحين من عباده.
والشئ المضمون للعبد هو رزقه الذى يحصل له به قوام وجوده فى دنياه.
ومعنى كونه مضمونا أن الله تعالى تكفل بذلك ، وفرغ العباد عنه ، ولم يطلب منهم الاجتهاد فى السعى فيه ، ولا الاهتمام له.
والشئ المطلوب من العبد هو العمل الذى يتوصل به إلى سعادة الآخرة، والقرب من الله تعالى من عبادات وطاعات .
ومعنى كونه مطلوبا أنه موكول إلى اكتساب العبد له ، واجتهاده فيه، ومراعاة شروطه وأسبابه وأوقاته .
بهذا جرت سنة الله تعالى فى عباده، قال الله عز وجل – فى المعنى الأول الذى ضمنه للعبد – وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ ) . وقال تعالى – فى المعنى الثانى الذى طلبه منه – ( وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ) . وقال إبراهيم الخواص : العلم كله فى كلمتين .. لاتتكلف ما كفيت ، ولا تضيع ما استكفيت .
وقال سيدى ابن عطاء الله السكندرى فى التنوير فى قوله تعالى : ( وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ ) أي قم بخدمتنا ، ونحن نقوم لك بقسمتنا ، وهما شيئان : شيء ضمنه الله لك ، فلا تتهمه ، وشيء طلبه منك ، فلا تهمله ، فمن اشتغل بما ضمن له عما طلب منه فقد عظم جهله ، واتسعت غفلته ، وقل أن ينتبه لمن يوقظه بل حقيق على العبد أن يشتغل بما طلب منه عما ضمن له ، إذا كان الله سبحانه وتعالى قد رزق أهل الجحود كيف لا يرزق أهل الشهود، وإذا كان سبحانه قد أجرى رزقه على أهل الكفران ، كيف لا يَجري رزقُه على أهل الإيمان؟ّ.
فمن قام بهذا الأمر على الوجه الذى ذكرناه من الاجتهاد فى الأمر المطلوب منه ، وتفريغ القلب عن الأمر المضمون له فقد انفتحت بصيرته ، وأشرق نور الحق فى قلبه ، وحصل على غاية المقصود ، ومن عكس هذا الأمر فهو مطموس البصيرة ، أعمى القلب ، وفعله دليل على ذلك.
فقد علمت أيها العبد أن الدنيا مضمونة لك ، أي مضمون لك منها ما يقوم بأَودكَ والآخرة مطلوبة منك ، أي العمل لها ، لقوله سبحانه وتعالى :{وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى} فكيف يثبت لك عقل أوبصيرة ، واهتمامك في ضمن لك – اقتطعك عن اهتمامك بما طلب منك من أمر الآخرة ، حتى قال بعضهم :{إن الله تعالى ضمن لنا الدنيا وطلب منا أمرالآخرة ، فليته ضمن لنا الآخرة ، وطلب منا الدنيا}.
الحكمة: 4
إذا كانت الهمم لا تخرق أسوار الأقدار، فالتدبير والاختيار والتخطيط لشؤون الحياة وضروراتها، كل ذلك مطلوب، ولكن وفق سنة العبودية، واستخارة علم الله، دون تعسف ولا تكلف، ولذا فالمؤمن يريح نفسه من التدبير الممقوت وهو ما كان على خوف من المستقبل وطمع بلا حدود، واهتمام زائد، يأخذ بالأسباب المطلوبة، ويعلم أن الخير كله فيما يختاره الله، ولذلك قال: “أرح نفسك من التدبير، فما قام به غيرك عنك لا تقم به لنفسك”.
والتدبير على ثلاثة أقسام: مذموم ومطلوب ومباح.
فأما التدبير المذموم فهو التدبير المصاحب للتكلف والهمّ والجزم والتصميم من غير استخارة الله وطلب حوله وقوته، وهو منهي عنه لأنه يناقض حقيقة العبودية.
وأما التدبير المطلوب فهو التدبير في الواجبات والطاعات مع تفويض المشيئة والنظر في القدرة الإلهية، وهذا يسمى بالنية الصالحة، ونية المؤمن خير من عمله، يقول النبي ﷺ فِيمَا يَرْوِي عَنْ رَبّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَال” إِنّ الله كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسّيّئَاتِ. ثُمّ بَيّنَ ذَلِكَ، فَمَنْ هَمّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا الله عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً”.
وأما التدبير المباح فهو التدبير في شؤون الدنيا والمعاش مع تفويض المشيئة لله تعالى وقدرته وعلمه وإرادته، وقوام العيش، كما قيل، حسن التقدير، ومِلاكهُ حسن التدبير، وروي عن أنس أن النبي ﷺ قال : “حسن التدبير نصف العيش” أخرجه القضاعي في مسند الشهاب
ولعل ابن عطاء الله يقصد بـ”التدبير” هذا النوع من التدبيرالمذموم، وهو سبب يؤدي إلى وجودَ التكديرِ، ومنازعة الحكمِة الإلهية والتقديرِ الرباني، يقول تعالى: “وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ ٱلْخِيَرَةُ … } وقال أيضا ” : يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ * ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ السجدة/5-6 .
وفي الحديث: عَن ابنِ عَباسٍ، قال: قال رَسول الله صلى الله عليه وسلم «إِنَّ العَبدَ يُشرِفَ عَلَى الحاجَةِ مِن حاجاتِ الدُّنيا فَيَذكُرُهُ اللَّهُ مِن فَوقِ سَبعِ سَماواتٍ، يَقُولُ: مَلائِكَتِي، إِنَّ عَبدِي هَذا قَد أَشرَفَ عَلَى حاجَةٍ مِن حَوائِجِ الدُّنيا فَإِن فَتَحتَها لَهُ فَتَحتُ لَهُ بابا مِنَ النارِ، ولَكِن أَرُدُّ بِها فَيُصبِحُ عاضًّا عَلَى أَنامِلِهِ يَقُولُ: مَن سَعَى؟ ومَن دَها لِي؟ ما هِيَ إِلاَّ رَحمَةٌ رَحِمَهُ اللَّهُ بِها»”، قال المُؤَلِّفُ: تفرد به صالح، قال الدارقطني: هو متروك.
قال داؤود – عليه السلام -: رب أي عبادك أبغض إليك؟ قال: عبد استخارني في أمر فاخترته له فلم يرض به..
ولا بد للمؤمن أن يعلم أن لله – تعالى -ألطافا خفية قلّما ينتبه إليها، يعتبرها الناس منعا وهي عين العطاء، ويظنونها محنة وهي منحة، فكم من رسوب أعقبه نجاح بامتياز، وكم من وجع كان سببا في اكتشاف مرض لو بقي مجهولا لكان خطرا على صاحبه، والخير فيما اختاره الله،
روى مسلم عن أَبي هُرَيْرَةَ رضِيَ الله عنهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : ” الْمُؤْمِنُ الْقَوِىُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِى كُلٍّ خَيْرٌ احْرِصْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَلاَ تَعْجِزْ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيءٌ فَلاَ تَقُلْ لَوْ أَنِّى فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا. وَلَكِنْ قُلْ قَدَرُ اللَّهِ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ ”
فالإنسان لو كنت يعلم حقيقة تدبير الله له، لازداد حباً فيه وشغفا به:
تـجـولت بالـفـكـر فـي هل أتى و قلت لقلبـي كفـاك الجليـل
يـدبـر امـري و لا عـلـم لــــي هو الله حسبي و نعم الوكيل
وأستحضر هنا قصة البطل العالمي في الملاكمة الأمريكي المسلم محمد علي كلاي حين وجّه له أحد الصحافيين سؤالا يقول فيه: هل عندك حراس شخصيون؟ فكان جوابه بلا تردد، نعم، لدي حارس شخصي واحد، هو يبصر بلا عيون، ويسمع بلا آذان، ويتذكر كل شيء دون مساعدة عقل أو ذاكرة، إذا أراد أن يخلق شيئا يقول له كن فيكون، أوامره لا ينقلها لسان أو تسمعها آذانـ يعلم الأسرار في أعماق خواطرنا، هو من يوقفهم، فمن يكون؟ هو الله، هو حارسي الشخصي، وحارسكم الشخصي، هو المتعالي الحكيم، ولا يمكنني أن ألومه في الحقيقة، لو كان لدي حارسشخصي لأخبرته أني لا أثق به، سأحترس منه وأصبح مرتابا، وأحترس من الناس، كلا فالله حارسي”.
قال القشيري بعد كلام في وجه اختصاص التدبير بالحق تعالى: لأنه لو لم تنفذ مشيئته واختياره لم يكن بوصف العِزِّ، لأن من نفى عن مراده لا يكون إلا ذليلاً، والاختيارُ للحق نعتُ عز، والاختيار للخلق صِفةُ نقصٍ، ونعتُ ملام وقصور، فاختيارُ العَبْدُ على غيرُ مُبَارَكٍ له، لأنه صفة غيرُ مستحِقٍّ لها، ومن اتصف بما لا يليق به افتضح. والطينةُ إذا ادَّعَت صفة للحقِّ أظهرت رعونتها، فما للمختار والاختيار؟! وما للمملوكِ والمِلْك؟! وما للعبيد في دَسْتِ الملوك؟! قال تعالى: { ما كان لهم الخيرة }.فإذا علمت، أيها العبد، أن الحق تعالى هو الذي يخلق ما يشاء ويختار، لم يبق لك مع الله اختيار، فالحالة التي أقامك فيها هي التي تليق بك، ولذلك قيل: العارف لا يعارض ما حلّ به، فقراً كان أو غنى.
قال اللجائي في كتاب قطب العارفين: الراضي شبه ميت، لا نفس له، يختار لها، فالفقر والغنى حكمان من حكيم واحد، وهو أعلم سبحانه بعبيده، وما يصلحون به، فمنهم من يصلح للفقر ولا يصلح للغنى، ومنهم من يصلح للغنى ولا يصلح للفقر، ومنهم من يصلح بالمنع ولا يصلح بالعطاء، ومنهم من يصلح بالعطاء ولا يصلح بالمنع، ومنهم من يصلح بالبلاء ولا يصلح بالصحة، ومنهم من يصلح بالصحة ولا يصلح بالبلاء، ومنهم من يصلح بالوجهين جميعاً، وهو أعلى رُتبة يشار إليها في غاية هذا الشأن، { وربك يخلق ما يشاء ويختار… } الآية، ففي هذه الآية كفاية وتعزية لكل سالك راض عن الله تعالى، لكن لا يعقْلُها ولا يتلذذ بها إلا مشايخ العارفين.
الحكمة: 3
إذا كان مصطلح الهمّ يطلق على بداية الإرادة وأولها، فإن الهمة تطلق على مرحلة قوة الإرادة ومنتهاها، وتوصف بالعلوّ والسبق، كما توصف بالسفول والتخلف، وتعرّف الهمّة العالية بكونها عبارة عن استصغار ما دون النهاية من معالي الأمور، وذلك حين يتوجه القلب ويقصد بكليته وجميع قواه الحسية والمعنوية جانب الحق والخير لحصول الكمال الممكن، غير أن همَّة الإنسان مهما علت، وقوةَ انبعاث قلبه مهما سمت، فإنهما لا يخرقان أسوار قضاء الله وقدره، ولا يكون شيء منهما في هذا الكون إلا بإرادة الله وقضائه، فهما يدوران مع القدر كيفما دار، لا حول لهما ولا قوة إلا بالعزيز القهار، «وكان الله على كل شيء مقتدرا» الكهف: 45
عن عبد الله بن عمرو -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله ﷺ: « كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ حَتَّى الْعَجْزُ وَالْكَيْسُ» رواه مسلم وأحمد وابن حبان ومسلم والبيهقي، ومعنى ذلك أن اجتهادَ المرء أمرٌ مطلوب، ولكن هذا الأمر مهما بلغ من الإحكام والإتقان لازمٌ وعاجزٌ عن خرق ما جرت به الأقدار، ولا يمكنه أن يأتي بنتيجة إلا إذا تحقق العون من الله، وإلا كان اجتهاد الإنسان سببا في الجناية عليه وخيبته، قال أحدهم:
إِذا لمْ يَكُنْ عَوْنٌ مِنَ اللهِ لِلْفَتى +++ فأوَّلُ ما يَجْني عَلَيْهِ اجْتِهادُهُ
وقد خلَق اللهُ الخَلْقَ وهدَى الناسَ إلى مَعرِفَةِ الخيرِ والشرِّ، وأرسَل الرُّسُلَ مبشِّرين ومُنذِرين، وموضِّحين الحقَّ، وجَعَل الحِسابَ والجزاءُ في الآخِرَةِ دونَ ظُلمٍ لأحدٍ، وهو سبحانه يَعلمُ أزلًا أحوال الناسِ ومساراتهم ومصائرهم يوم القيامةِ، وفي هذا الحديثِ يقول عمرانُ بن حُصين رضي الله عنه: قال رجلٌ: «يا رسولَ الله، أَيُعْرَفُ أهلُ الجنَّةِ مِن أهلِ النَّارِ؟ »، فقال النبيُّ ﷺ: نَعَم، فقال الرَّجلُ: « فلِمَ يعملُ العامِلون؟! » ، فقال النبيُّ ﷺ: « كلٌّ يعملُ لِمَا خُلِق له» أو « لِمَا يُسِّرَ له» رواه البخاري
فكلُّ إنسانٍ يعملُ في الدُّنيا، وقد أعطاه اللهُ وسائلَ التَّميِيزِ بينَ الخيرِ والشرِّ، وبيَّن له طريقَ الحقِّ والباطلِ، فكلُّ إنسانٍ يختارُ مِن الأعمالِ ما يُرِيد، ويوصِّله يوم القيامة إلى المصيرِ المحتومِ الجنَّةِ أو النَّارِ، ولكنَّ النِّهايةَ مجهولة، والمآلَ مخفيٌّ عن النَّاسِ لحكمةٍ يَعلمُها اللهُ عزَّ وجلَّ.
وقد علم الله في الأزل ما سيخلقه من عباده، وعلم ما هم فاعلون، وكتب كل ذلك في اللوح المحفوظ، وخلقهم الله كما شاء، ومضى قدر الله فيهم، فعملوا على النحو الذي شاءه فيهم، وهدى مَن كتب الله له السعادة، وأضل مَن كتب عليه الشقاوة، وعلم أهل الجنة ويسرهم لعمل أهلها، وعلم أهل النار ويسرهم لعمل أهلها، قال تعالى: «وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ» الصافات:96، وقال: « وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ» الصافات:52، وقال: «وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنثَى وَلا تَضَعُ إِلا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ وَلا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ» فاطر:11، وقال: «مَن يَهْدِ اللّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ» الأعراف:178، وقال: «إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ» النحل: 125، وجاءت أحاديث كثيرة تواتر معناها على أن رب العباد علم ما العباد عاملون، وقدّر ذلك وقضاه وفرغ منه، وعلم ما سيصير إليه العباد من السعادة والشقاء، وأخبرت مع ذلك كله أن القدر لا يمنع من العمل،« اعملوا فكل ميسر لما خلق له». رواه البخاري
فكل شيء سابق في علم الله، جرى به القلم قبل الخلق، واجتهاد الإنسان لا يمكنه أن يخالف ما جرى به القدر والقلم ، عَنْ عبد الله بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما ، قَالَ: « كُنْتُ خَلْفَ رَسُولِ الله ﷺ، فَقَالَ: « يَا غُلَامُ إِنِّي أُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ ، احْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ، احْفَظِ اللَّهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ ، إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ ، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ ، وَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ ، رُفِعَتِ الأَقْلَامُ وَجَفَّتْ الصُّحُفُ» رواه الترمذي.
ومن شأن الإيمان بهذه بما جاء في حكمة ابن عطاء الله هذه، أن تزرع في قلب المؤمن أمورا، نختصرها في أمور:
الأمر الأول: أهمية المسارعة إلى الخيرات، والعمل على طرق أبواب الرزق، والسير وفق سنن الله في الخلق، والسير في الأرض طلبا للأرزاق الحسية والمعنوية، يقول تعالى: «هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۖ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ » الملك: 15، فمن نعم الله على خلقه أن سخر لهم الأرض وما فيها، وذللها لهم، وهيأ فيها المنافع ومواضع الزروع والثمار، والإنسان مأمور بأن يمدّ يديه، ويتحرك برجليه، ويسافر في أقطارها ، ويتردد في أرجائها بأنواع المكاسب والتجارات، دون أن ينسى أن سعيه لا يجدي عليه شيئا ، إلا أن ييسره الله له، ولهذا قال: « وكلوا من رزقه » فالسعي في السبب لا ينافي التوكل كما قال الإمام أحمد، عن عمر بن الخطاب يقول: إنه سمع رسول الله ﷺ يقول : « لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله، لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا» رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث ابن هبيرة وقال الترمذي : حسن صحيح .
ومحل الشاهد في الحديث أن النبي ﷺ أثبت للطير حركة وتفاعلا مع قوانين الله وسننه في الأرض، بالرواح والغدو لطلب الرزق ، مع توكلها على الله ، عز وجل ، وهو المسخر المسير المسبب، ولا تعارض بين الأمرين إلا في عقول أشباه المتدينين الجاهلين للسنن والقواعد.
والأمر الثاني: المستفاد من حكمة ابن عطاء الله، هو عدم اليأس والإحباط في حالة عدم النجاح في الوصول إلى المبتغى، والعمل المرتضى، باعتبار أن الهمة تبقى عاجزة عن تحدي الإرادة الالهية والأقدار الربانية، قال تعالى: « مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ» الحديد: 22
والأمر الثالث: الذي نستخلصه من حكمة ابن عطاء الله يتعلق بأهمية غرس روح السكينة والتفاؤل في قلوب المؤمنين، وذلك بالدعوة إلى شدة التعلق بالله، والتوكل عليه، فالمؤمن كما أنه مطالب بالعمل والأخذ بأسباب العيش، فهو مأمور بأن يذعن لقانون الاختيار الإلهي، والحذر مهما كان سابقا فإنه لا يغني عن القدر، وبذلك يتحقق الأنس بالله، وتزول الوحشة.
الحكمة: 2
الحكمة: 1
.من أبرز الدلائل على اعتماد الإنسان في نيل المرغوب على عمله، نقصان رجائه عند الوقوع في الذنب، فالمؤمن لا يعول لنيل رضا الله على عمله الصالح، بل على لطف الله، صاحب التوفيق والفضل
قال رحمة الله عليه: مِنْ عَلامَةِ الاعْتِمادِ عَلى العَمَلِ، نُقْصانُ الرَّجاءِ عِنْدَ وُجودِ الزَّللِ.
ابتدأ ابن عطاء الله حكمه بهذه الحكمة؛ وفيها تأكيد على أهمية التوكل على الله المتأصلة في خطاب القرآن الكريم والسنة النبوية، فالنفس الإنسانية حينما يخونها التوفيق تأنس بالسبب وتتناسى المسبب، وتعتمد على المفعول وتتجاهل الفاعل حقيقة، والمؤمن اعتماده على ربه وخالقه، لا على نفسه وعمله، وحينما يقع الاعتماد على العمل فذلك دليل على انطماس الرؤية، وانحسار البصيرة، فما الدليل على الاعتماد على العمل يأتي الجواب من ابن عطاء الله ويقول: مِنْ عَلامَةِ الاعْتِمادِ عَلى العَمَلِ، نُقْصانُ الرَّجاءِ عِنْدَ وُجودِ الزَّلل.
والمعنى أن من علامات الاعتماد على العمل الإعجاب به، ونسيان رؤية المنة والتوفيق من الله ة فيما يجري الله لك من الطاعات، وينشأ عن ذلك التنقيص ممن لم يعمل بمثله، وازدراؤه، والمؤمن يعتمد على سابق علم الله ومدده دون علمه وحيله، ولو أنه لو عمل كل الطاعات وقام بكل الواجبات فإنه لا يرى لنفسه فضلا ولا مزية، قصر نظره، وعكف بنظره على امتثال أمر مولاه، دون الانبهار بحظ عاجل، أو جزاء آجل، قد خرج من ستار الحجاب عندما يتوهم أن صدور أعماله عنه أو كونه منه؛ فإذا نظر إلى ما يبرز منه في صورة طاعة علم أن ذلك نعمة من نعم الله، وعية من عطاياه، أنعم الله بها عليه كما أنعم بسابق هدايته ، وإيجاده من العدم، وإرسال أنبيائه وإنزال كتبه، وبسط أرضه ورفع سماواته، وتسخير موجوداته، {وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها} [النحل:18].
فكن على كرم الـرحمن معتمــدا لا تستند لا إلــى عــــلم ولا عمــل
ففضل ربــــك لا تمنعه معصية ولا يضاف إلى الأغراض والعلل.